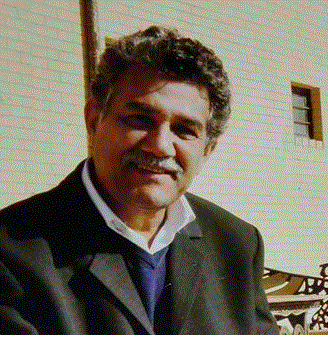عبدالأمير الركابي
- إعلان -
الانتفاضات العربية التي تفجرت عند مفتتح عام 2011، اثارت موجة من الاطلاقية التغييرية، بدت كالعادة من دون مواكبة عضوية على مستوى الافكار، ومن ثم ارتجالية، وحلموية، يؤجج لهفتها للتحقق، وبلوغ الاهداف، ركام الحرمان والتهميش. لا مكان حسم للافكار، والشيء الوحيد الحاضر اننا دخلنا عصر الثورات، وان هذه سوف تحقق اهدافها، او انها من الطبيعي ان تحقق تلك الاهداف، وفوراً. ساد مع الربيع، او فوق جبينه، شعار «الثورة معناها حتمية انتصار الثورة وبديهيته»، لا قلق على الاطلاق ازاء احتمال الفشل، او التعثر. ما عزز مثل هذا الشعور، او الاعتقاد، مجريات الحالة التونسية على وجه الخصوص. لم يكن مطروحاً وقتها، والى الآن، توصيف حالة تونس كخروج على السائد، لا أحد فكر بأن يسمي تونس البلد السهل، تسمية من قبيل «بلد كن فيكون». المقارنة بحالة دول المشرق، مستبعدة جداً، لا تخطر على بال، وقد تكون مستهجنة.
عززت بدايات الانتفاضة المصرية اللاحقة، الفكرة نفسها: «الربيع ينتصر». لكن الحصان الذي استمر يجري هو تونس، مصر تعثرت. تعثرت في بعض الاحيان كثيراً، ولدرجة مخيفة. «الاخوان المسلمون» يريدون الحصول على منصب رئيس الجمهورية أيضاً. قدموا مرشحهم، وفوراً قدم عمر سليمان ترشيحه، ذهب حسني مبارك، جاء نائب حسني مبارك. دارت الدورة بسرعة، فأصبح للعسكر او المجلس العسكري ممثله هو الآخر، ومع تفتت المشهد الرئاسي المصري، كثرة المرشحين، واحتمال تشتت الاصوات، والتزوير، النظام السابق مدعوماً بالعسكر، يتمتع حالياً بحظوظ جدية بالفوز بمنصب الرئاسة. واذا فاز عمر سليمان فعلاً، نكون قد عدنا الى حيث بدأنا. الانتفاضة السورية انتقلت من السلم الى السلاح، معارضتها التي تعتاش حتى الآن، على بداهة الثورة، وحتمية انتصارها السريع، تتفكك، والاوضاع الدولية والعربية حولها تضطرب، وتتسبب لجمهورها بالاحباط. والتساؤلات تتراكم، والمقارنات تطلق من داخلها مؤشرات لمأزق بين كارثتين حالّتين على الشعب السوري ومصيره، كارثة مصدرها النظام. وكارثة سببها المعارضة. في اليمن لا نستطيع القول إن الكثير قد تحقق، ما زال النظام (بقاياه) يحتل المطارات، ويرفض القرارات ويشترط. ماذا في ليبيا؟ وقبل الكل، ماذا حدث في العراق؟
هل هذه اسباب تبرر طرح احتمال الثورة على مرحلتين؟ يقتضي هذا التخلص فوراً من قطعيات الثورة المهيمنة حتى الآن، في غير اوانها ولا محلها. لم تنتصر الثورات بعد، وهي لم تكن بالاصل ثورات مكتملة المقومات، اذا زنّا شروطها وقواها، ديناميات حركتها. يمكن ان نسميها انتفاضات مرشحه لأن تتحول الى ثورات، هذا محتمل. لكن بعد توافر شروط اخرى لا تزال غائبة. الناقص ربما، التجارب، بعد التعثرات وتراكمها. فحينما لا تكون الثورات مكتملة العناصر، وتحدث هبات طموحها التغيير والحرية، يطلق عليها اسم «انتفاضات»، الثورات هي نهضات كبرى، تنطوي على عناصر ومقومات متكاملة، تؤدي بها الى النصر غالباً. النهضات الحالية تفتقر الى الرؤية، والى النواة القائدة المحنكة والحكيمة. لا افكار تواكبها، ولا قوى سياسية من نسيج يتعدى في تكوينه وطبيعته، الحاضر الى المستقبل. فليس كل من خرج من بلاده معترضاً، هو بالضرورة قائد تاريخي ملهم، التجارب هي التي تصنع امثال هؤلاء، المواجهات والمصاعب. ماذا نسمع من هؤلاء غير ايقونة «الدولة المدنية»؟ هل من حديث عن الآليات، عن الابتكار التكتيكي، عن الفارق الثقيل بين الاهلي والمدني، عن خليط الافكار الحداثية المستعارة والمستعادة، عن منطق «الغزو» والغزو المضاد بين الطوائف والملل، عن مقتضيات تغيير السردية التاريخية والحديثة، عن الجوهري المتعلق بالوعي، وليس الاجرائي المتداول والمنقول، عن التناقض بين الاجرائي والشعبي الاهلي، عن فداحة النقص المسقط من الحساب اعتباطاً، على رغم حيويته الحاسمة، ونقصد لازمة الفكرة المبدعة والتنوير، لا الانشائية المترجمة بل المبتكرة عياناً؟ وعن وعن…
الثورة لم تدخل المسرح كاملة بعد، وما رأيناه هو مقدمتها، طليعتها، من الخطل والتضليل ان نعلن حصول «الثورة» في غير اوانها. هذا يتضمن ليس قصوراً فحسب، بل استغلالاً، وحجراً على الثورة داخل اطار ومفهوم ادنى من افقها. ما نسمعه في كثير من الاحيان، هو ضعف شعور بالمسؤولية، وقلة اعتبار واستخفاف بالقضايا الكبرى، لن نقول استخداماً لقضية مضيئة، تستوجب محاكمة مستغليها، وبالاخص النخب المتصدية للقيادة كمعارضة، وكمتابعات و «افكار» في ظل غياب الافكار. يعني ذلك، ان هذه الحالة هي نفسها، موضوعة في جدول اعمال الانتفاضات. لا بد من تجاوز نمط المعارضات الحالية، العبور عليها، وعلى وعيها الراهن وسلوكها، وادانة المتصدين للتوجيه، والقراءة الجزئية، حيث يروجون الاوهام ويتصرفون بسطحية وخفة.
من مظاهر الخطل في هذا الاداء، استعجالية تحاول عصر الزمن، كأنها تتعامل بروح العملية القيصرية، لهذا يسود جزع، اذا تأخر الصراع ولم يحسم بين ليلة وضحاها على جبهة المعارضة. مثلما يهيمن الجزع على النظام، كلما وضع سقفاً زمنياً لانهاء الاعتراض، ووجده مجرد عتبة على طريق يمتد بلا نهاية. الزمن حاضر في الحالة السورية بقوة على المنقلبين. كأنه هو الذي يقول الكلمة القاطعة، وهو الذي يقرر المصائر ويبدلها، بالاخص على مستوى القيادة. فالذين استعجلوا واقحموا الناس في مواجهات مكلفة، وغير محسوبة، ولا مضمونة النتائج، ينتظرهم الاستبعاد من الواجهة. والذين يقتلون ويدمرون على امتداد المراحل، يراكمون نقاطاً تجعل من بقائهم مستحيلاً. هذا الزمن وحضوره حمال معان ودروس، قد تعني عدم نضج اسباب التغيير، قد تعني خصوصيات غير مستخلصة، قد تعني ولادة متعسره لاسباب واقعية اوطارئة دولياً، لكن اين هي «الثورات» التي انجزت مهماتها كاملة. كلها متعثرة، والفرق كما يبدو في التفاصيل.
هل يجوز والحالة هذه، ان ننظر الى العراق وتجربته في هذا المجال، وصولاً الى اعتباره حالة «ريادية» بمعنى ما. وان نذهب لحد استخلاص الدروس من مساراته التي تعلمنا، بأن «التغيير» قد يفضي في العالم العربي، او هو يفضي عادة، ان لم نقل حتماً، الى نشوء حالة تجعل منه مهمة انجازها التاريخي محكوم بطورين ومرحلتين. فالديكتاتورية الانتخابية، وتحكم مكونات ما قبل الدولة، مع استمرار اشكال اخرى من الطغيان، واجهته الفساد والمحاصصات والنهب، وتحويرات الردة وتزويرها للمفاهيم عملياً، تدعمها منظومة مفهومية شديدة الرسوخ، وواقع تاريخي قاعدته مجتمع اهلي، مشبع بالجمود وقوة الماضي، ما يجعل من مسألة العمل على خوض معركة ما بعد التغيير، هي الفاصلة والتاريخية. ومع ان لكل حالة وكل موضع تفاصيله، واشكالات تحوله، وظروفه، الا ان ما يمكن القول به وتعميمه بعد التجربة، وقطعاً: ان ثورة واحدة في العالم العربي لا تكفي.